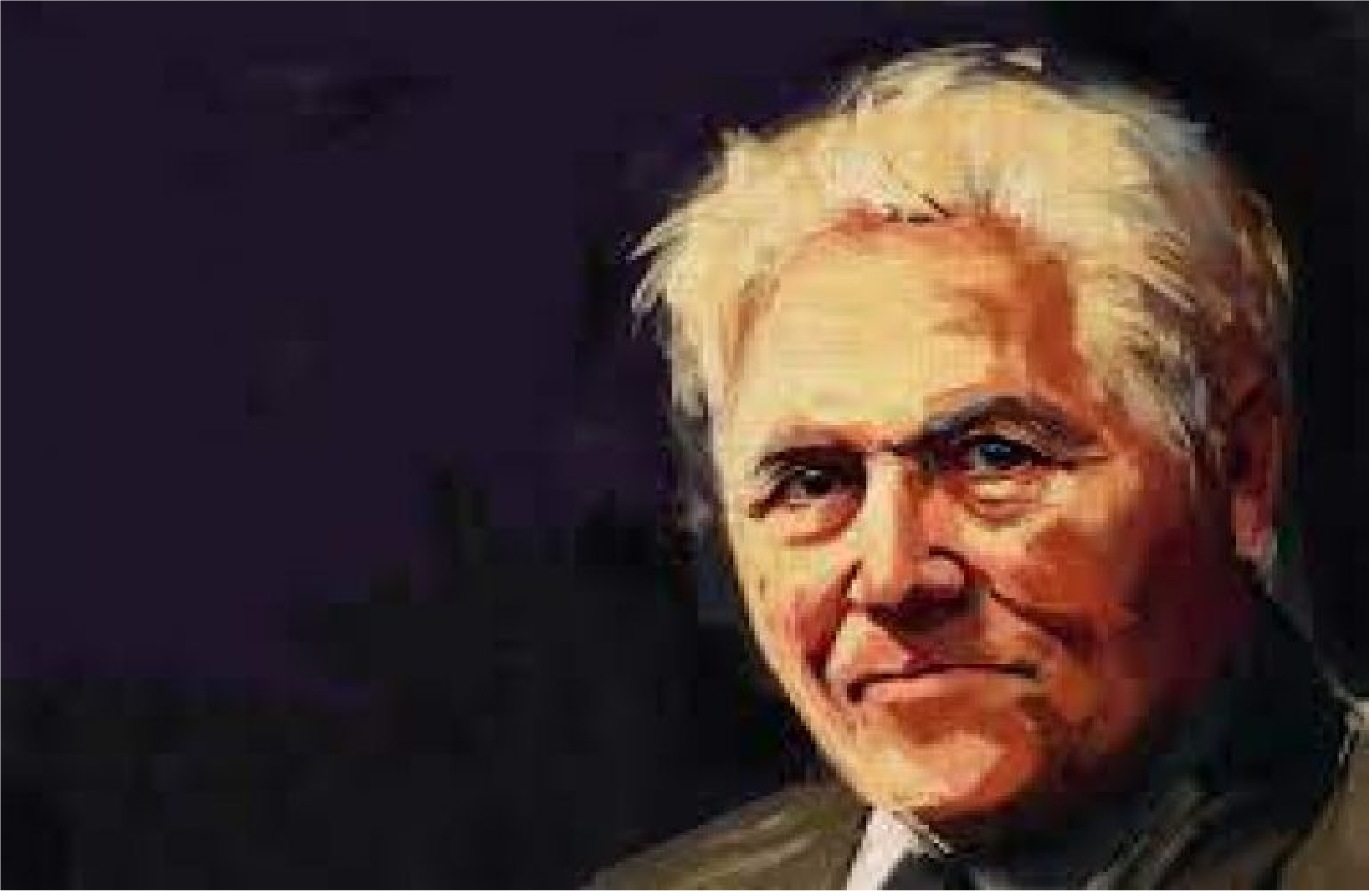تمغربيت:
إخراج المعنى من اللفظ، التوجّه بالنظر إلى اللغة والخبر اليقين حصرا.. إهمال النظر على أساس من التجربة والواقع الملموس، الخ.. هذه ظواهر ثقافية سببها “محاولةُ عقلِ مطلقٍ عصي عن العقل”. والحصيلة:
– “ما كان أفقا لابن رشد أصبح حدا لمحمد عبده” بتعبير عبد الله العروي.. مفارقة عبده أنه اكتشف “ضعف وتخلف المسلمين رغم قوة وعقلانية شريعتهم”.. عكس ما يدّعيه المستشرقون من مناقضة الإسلام للحرية والتجربة، ومن تبريره الاستبداد. لكل ذلك يقول محمد عبده: “لا، الإسلام عكس ما تدّعون”. الدفاع عن “مطلق ما” هو ما أبقى محمد عبده حبيس ابن رشد، في زمن تجاوزه (إلى النظر التجريبي).
تصالح أفلاطون وأرسطو في الفلسفة الإسلامية
– “تصالح أفلاطون وأرسطو في الفلسفة الإسلامية، وهذه ذابت في الاعتزال.. وهذا انحل في الكلام السني والزيدي، الخ”؛ فقد بقي “المطلق” رقيبا على كل الفرق الكلامية، بما فيها المعتزلة المدرسية.. لا معتزلة الموقف (كانت سابقة واحتمالية جدالية أكثر منها تقريرية).
– “اعتماد وتلقي المنطق الأرسطي مفصولا عن سياقه الاستقرائي”.. عملية أخضعت المنطق عند المسلمين ل”الاستبطان”، استبطان المطلق في كل عملية منطقية. لظروف سياسية واقتصادية لا يذكرها العروي، حال هذا “الاستبطان” دون ترميز المنطق وتطويره إلى رياضيات احتمالية.. ودون تطويره إلى منطق تجريبي استقرائي.
* تعليق على كلام العروي:
لا يمكن وضع حدود للمطلق، ليس من منظور الفلسفة أو العلم، بل من منظور الدين نفسه.. ف “كل ما خطر ببالك فربك بخلاف ذلك” (قاعدة عقدية)، “ولا يحيطون به علما” (قرآن كريم)، إلخ.
فلما أرادوا أن يضعوا له حدودا، لا المطلق أدركوه في تجريده (إدراك التجريد لا إدراك التحديد).. ولا العقل وضعوه في مواجهة الطبيعة والتاريخ.