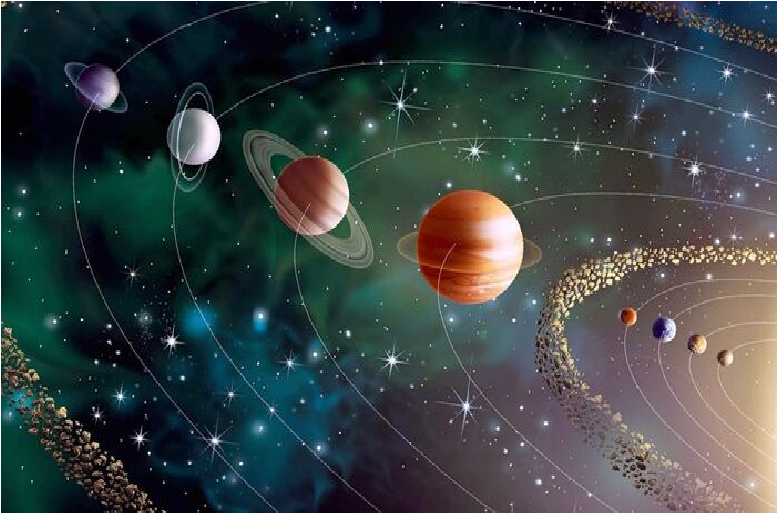تمغربيت:
طفى على السطح، مؤخرا، نقاش جديد-قديم حول “العلوم الكونية”، ومدى أهميتها بالنسبة للمسلمين. وبغض النظر عن أهمية هذه العلوم، فإن استحضارها كنقيض للعلوم الإسلامية مثير للريبة! فهذه مجالها الغيب وتفسير خطابه، وتلك مجالها الشهادة وكشف قوانينها (الطبيعة) وقواعدها (الإنسان). لماذا الخلط إذن؟!
ينقسم الناس في هذا النقاش قسمان:
– دعاة تفريق: لا يرون من العلم إلا علوم الشريعة، أو لا يرون منه إلا علوم الكون. العالم عند هؤلاء عالم مادي لا يقبل التجاوز، وعند أولئك عالم غيبي تفسيراته الكامنة أوهام.
– دعاة توفيق: يجتهدون ليجدوا في أقوال الفقهاء والمتقدمين ما يدل على توفيق، ويبحثون في علوم الكون عن الشرع وكثيرا ما وجدوه.
وغرضنا في هذا المقال “كشف الغطاء” عن “العلوم الكونية”، المعين الوحيد للقائلين بمادية العالم على الإطلاق، الرافضين لكل تفسير متجاوز (“الكمون/ التجاوز”، من النموذج التفسيري لعبد الوهاب المسيري، راجع “الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان”). وذلك من خلال الإجابة على ثلاثة أسئلة:
– هل هناك “علوم كونية”؟
– وظائف العلوم الدقيقة والإنسانية وحدودها؟
– أوهامها؟
ملاحظات..
*هناك منحى كوني للعلوم، بحكم أن الإنسان واحد، كما أن الطبيعة واحدة؛ ولنا على القائلين بهذا المنحى، وأغلبهم متعصبون له؛ لنا عليهم ملاحظتان:
– رغم الكونية، هناك اعتبار للخصوصيات؛ يقل هذا الاعتبار في الأبحاث الطبيعية، ويتعزز في الأبحاث الإنسانية والاجتماعية. الخروج من الأرض إلى غيرها من الكواكب في نفس المجرة (التبانة)، فضلا عن خارجها.. يجعل لخصوصية الطبيعة معنى. أما فيما يتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، ورغم مقولة “الإنسان عالمي”.. ف”نمط الإنتاج الآسيوي” غير الإقطاع، واللاوعي المشرقي غير اللاوعي الغربي، إلخ.
– وإذا كانت الكونية نسبية في الشهادة، ما دامت نتائجها استقرائية أكثر مما هي إسقاطية تطبيقية.. فبأي حق سيتم إضفاء الطابع المادي واللاغيبي على الإنسان، بل على العالم ككل.. في فضاء شاسع لا نعلم عن محيطنا منه إلا القليل؟! وبأي حق سيتم التسليم لقواعد “الشعور واللاشعور” في نفس عميقة، من شدة عمقها استعصى التحكم في أجزائها الأكثر دنوا؟! إن التفسير المادي مهم، إلا أنه لا يلغي السؤال الفلسفي في شقه الوجودي، ولا يقفز على الميتافيزيقا في عالم من القصور المعرفي.
*تعتبر العلوم الدقيقة “علوما كونية”، تعني “العلم بالعلاقة الجدلية الضرورية بين التنظير المُرَيّض والتجربة والقياس الدقيقين” (“تاريخ العلم”، هشام غصيب). دافع رونيه ديكارت عن أحقيتها بتفسير الطبيعة، بعد قرون من احتكارها من قبل الكنيسة. ولأن شروط مواجهة الكنيسة لم تكن قد نضجت في عصره، فقد اكتفى بالتمييز بين ما للغيب وما للشهادة.
لماذا فعل ذلك؟
لأن بورجوازية عصره، البورجوازية الصاعدة في أوروبا الإقطاع، كانت في حاجة إلى تطوير قوى إنتاجها، وهذا في حاجة إلى معرفة قوانين الطبيعة، من فيزياء وكيمياء ورياضيات وفلك، إلخ.
دور العلوم الكونية إذن، تطوير قوى الإنتاج، والتأثير على علاقات الإنتاج نفسها. ساهمت إلى حد بعيد في فهم الكون بكيفية مختلفة عن التي انتشرت في عصور سابقة، إلا أن ما يهم الرأسمال منها هو تطوير قوى الإنتاج في حدود ما يحقق أرباحه ويحفظ نظامه.
واليوم يستفيد منها، بكيفية أخرى، حيث يتم استغلال بعدها المادي والوضعاني، في نشر الغريزية والاستصنام للتاريخ والطبيعة على حساب الوجدان (العقائد والخصوصيات اللاوعيانية)، من جهة؛ كذا لمواجهة كل ما هو تاريخي يحيل على إمكانية التغيير ونزع “الخلود” عن النظام الاجتماعي الرأسمالي، من جهة أخرى.
تفتح المختبرات الغربية أبوابها لهواة الكوانتيك (علم يدرس العناصر الدقيقية في الكون) والكوسمولوجيا (علم يدرس الفضاءات الشاسعة في الكون)، لعلهم يفسرون بأبحاثهم قضايا مستغلقة، من قبيل “من أينا جئنا؟” و”إلى أين المصير؟”؛ ولا جديد فوق الطاولة لحدود الساعة، عدا فرضيات لا تبلغ مداها، تتسم بالدقة في أجزاء منها، وتبقى أجزاؤها الأخرى فراغات تنتظر من يملأها.
لا جديد على الطاولة إذن، فتحتفظ العلوم الكونية على وظائفها الثلاث:
– تطوير قوى الإنتاج.
– تفسير عالم الشهادة بالعلم الدقيق.
– الاستغلال الإيديلوجي ذو النزعتين الإلحادية والوضعانية.