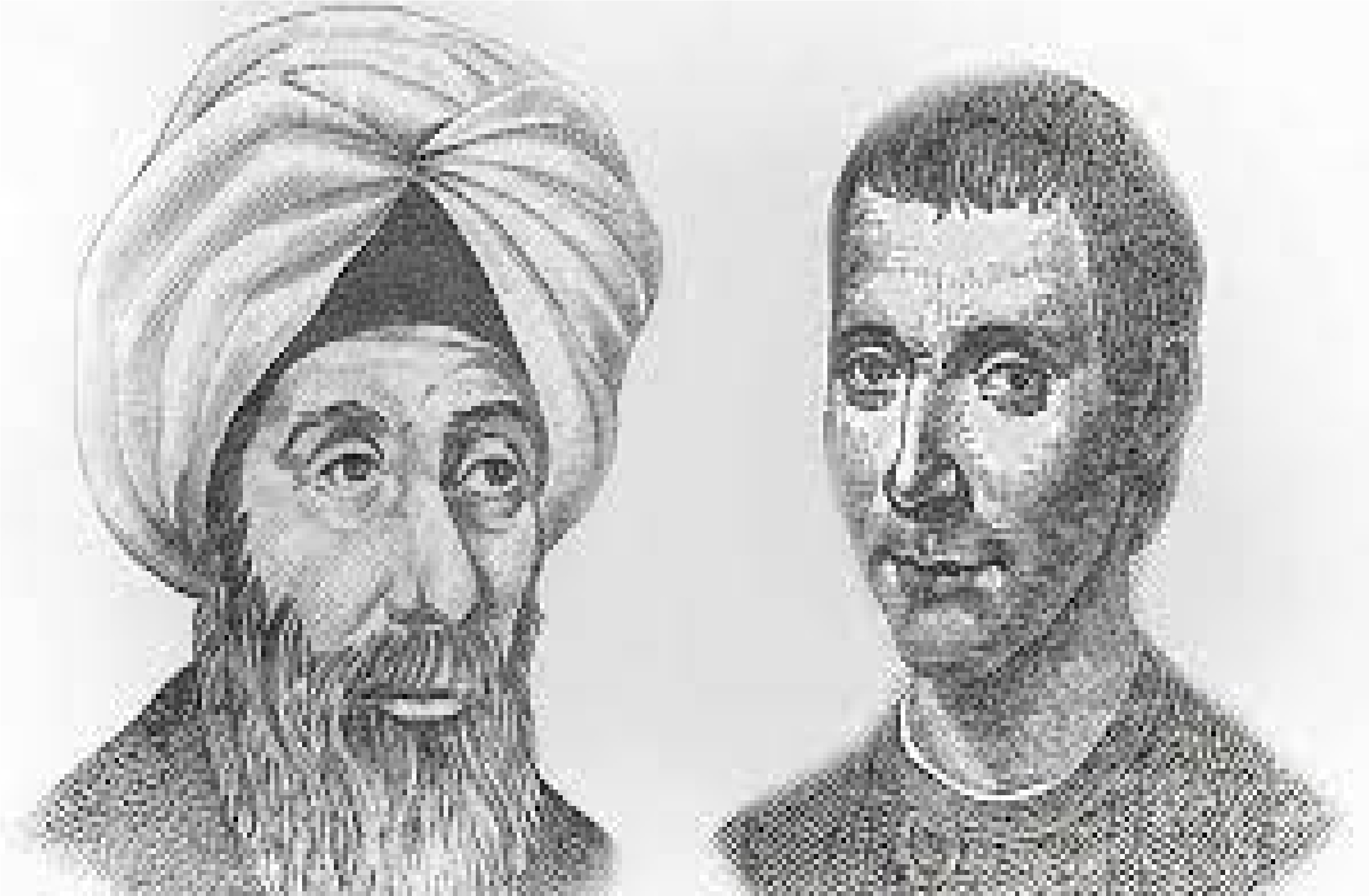تمغربيت:
– ابن خلدون في سياقه التاريخي
تحدث عبد الله العروي عن ابن خلدون في مواطن عدة، منها: حديثه عن “الخلدونية” في “مجمل تاريخ المغرب”، ومقارنته بين ابن خلدون ومكيافيلي في “مفهوم الدولة” وفي دراسة أخرى مستقلة، في “مفهوم التاريخ” وكذا “مفهوم العقل”، وغيرها من المواطن.
لا يعفي هذا الإعجاب بابن خلدون من مشرحة العروي النقدية، حيث إثبات عبقريته في سياق تاريخي أعجزه وحال بينه وبين اختراق حجب معرفية أخرى. لا بد من تحديد هذا السياق إذن، ما سمته وما جوهره؟.. يجيب العروي: عاصر فتنة سياسية واضطراب في الحكم. (انظر “مجمل تاريخ المغرب”)
– عبقرية ابن خلدون:
مكن هذا العصر المضطرب ابن خلدون من التأمل في طبيعة الحكم في الأرض. ليس الحكم عنده توجيها سماويا ولا تسديدا من لدن حكيم عليم.. إلا في حالة استثنائية –كاد ابن خلدون أن يقول بارتفاعها إلى الأبد- هي: الخلافة. لا تتحقق الخلافة إلا بمعجزة، فلا أمل في انتظارها.
همّ ابن خلدون بتجاوز مناهج الفقهاء والمؤرخين والفلاسفة في مناقشة الواقع السياسي العربي، إلا أنه لم يتخلص منها بشكل نهائي. فحافظ على طوباوية الفقيه بانتظاره معجزة الخلافة.. ونزع إلى فردانية الفيلسوف بوضعه هدف الدولة خارج إطارها، وتبنى واقعية المؤرخ بمناقشته الحكم كحكم واقعي وليس كمجال يُنْصَح فيه للسلطان. لقد كان ابن خلدون، بحق، ملتقى كل هذه الاتجاهات. (أقر بها العروي في فقرة من ص 93، مفهوم الدولة)
يحتفظ ابن خلدون في نفسه وعقله بتأثير من الفقيه ،الفيلسوف أو المؤرخ.. ويمكن ملاحظة ذلك في الترتيب الذي اقترحه لأنظمة الحكم. يكون الملك في البداية طبيعيا، ثم يتحول إلى ملك سياسي يحقق مصلحة الحاكم.. ثم إلى ملك سياسي يحقق مصلحة العموم، في انتظار معجزة الخلافة حيث الكمال والسداد بالوحي. يهتم “المؤرخ” في ابن خلدون بالملك الطبيعي والسياسة العقلية مهما كانت المصلحة التي تتغياها (مصلحة الحاكم أو مصلحة العموم). أما “الفقيه والفيلسوف” فيه، فيهتمان بالخلافة (=المدينة الفاضلة) ويناقشان هدف الدولة خارجها.
في هذا الصدد يعلق العروي: “لكن في واقع الإسلام.. هناك فرق وانقطاع، لأن العرب لم يعرفوا سياسة عقلية، لأنهم لم يعرفوا مدينة حضرية قبل الإسلام. فالإسلام هو الذي حضرهم.. لذلك جاءت مرحلة الخلافة مباشرة بعد مرحلة الحكم الطبيعي.. ثم لم تلبث أن اصطدمت مع السياسة العقلية الفارسية بخاصة، فاختفت تحت ضرباتها لأسباب معروفة. وهذا وضع خاص بالإسلام، ستكون له آثار وخيمة في تطور الفكر السياسي الإسلامي”. (ص 95)
الخلافة نبوية بالأساس، محتملة ومنتظرة في المستقبل بوقوع معجزة جديدة. لا يعفي هذا الدارسين من تفسير الحكم بسنن الطبيعة.. بل يحثهم على ذلك ويدفعهم إليه دفعا. الملك الطبيعي هو الأساس في كل دولة.. أما “الشرع والعدل” فهما عرضيان يزيدانه قوة فقط. هكذا تحدث ابن خلدون، وهذه هي عبقريته في نظر عبد الله العروي.
يقول عبد الله العروي موضحا موقف ابن خلدون: “إن الأساس في أية دولة، إسلامية كانت أو غير إسلامية، هو الملك الطبيعي المبني على العصبية.. تزيده الدعوة الدينية قوة لكن لا تغير مجراه”. (ص 97)
ما الدولة؟
امتعض الفلاسفة من واقعهم، فهموا بهجره إلى الأبد. يطمح ابن خلدون معهم إلى نفس ما يطمحون إليه (=المدينة الفاضلة).. ولكنها في نظره لا تتحقق إلا بمعجزة صعبة المنال، إن لم يكن منالها مستحيلا. وما دامت المعجزة كذلك، فلا مناص من الانكباب على دراسة الدولة انطلاقا من البحث عن سننها الطبيعية. فر الفلاسفة إلى الفردانية، في حين اهتم ابن خلدون بالدولة كما هي في عصره (وبالضبط في المنطقة التي عاش فيها).
يقول العروي: “إن ابن خلدون يوافق على أهداف الفلاسفة، لكنه لا يقبل إهمال وازدراء الواقع بدعوى أنه ضلال كله”. (ص 113)
لم يهمل ابن خلدون واقع الدولة كما فعل الفلاسفة. إنه بالنسبة إليه، واقع غلبة واستيلاء، إذ الدولة عنده “آلة قهر وغلبة واستغلال بالملذات وبالمفاخر”، كما أنها “مدة استيلاء جماعة مخصوصة على السلطة والمال”. يتكلم ك”محلل اجتماعي”، فيقول: “الدولة آلة قهر”. يتكلم ك”مؤرخ وفيلسوف تاريخ”، فيقول: “الدولة مدة استيلاء جماعة”. (ص 114)
– ابن خلدون ومكيافيلي:
يصف ابن خلدون دورة الدولة كمؤرخ، ويعطي بعض التفسيرات كفيلسوف تاريخ، ويهتم بالآليات القهرية للدولة كاجتماعي، ولكنه يضع هدف الدولة خارجها، كما يفعل الفقهاء والفلاسفة. يبقى واحدا منهم مهما تجاوزهم، يحده سياقه مهما اتصف بالعبقرية.
“يضع ابن خلدون مقاصد الشريعة فوق أهداف الدولة”، فلا يمتلك نظرية للوعي بها. وعكسه، “يرى مكيافيلي في قانون الدولة هدفا لكل مشروع بشري”، يؤطر كل هدف بالدولة، فيمتلك بذلك نظريتها. (ص 123-124-125)