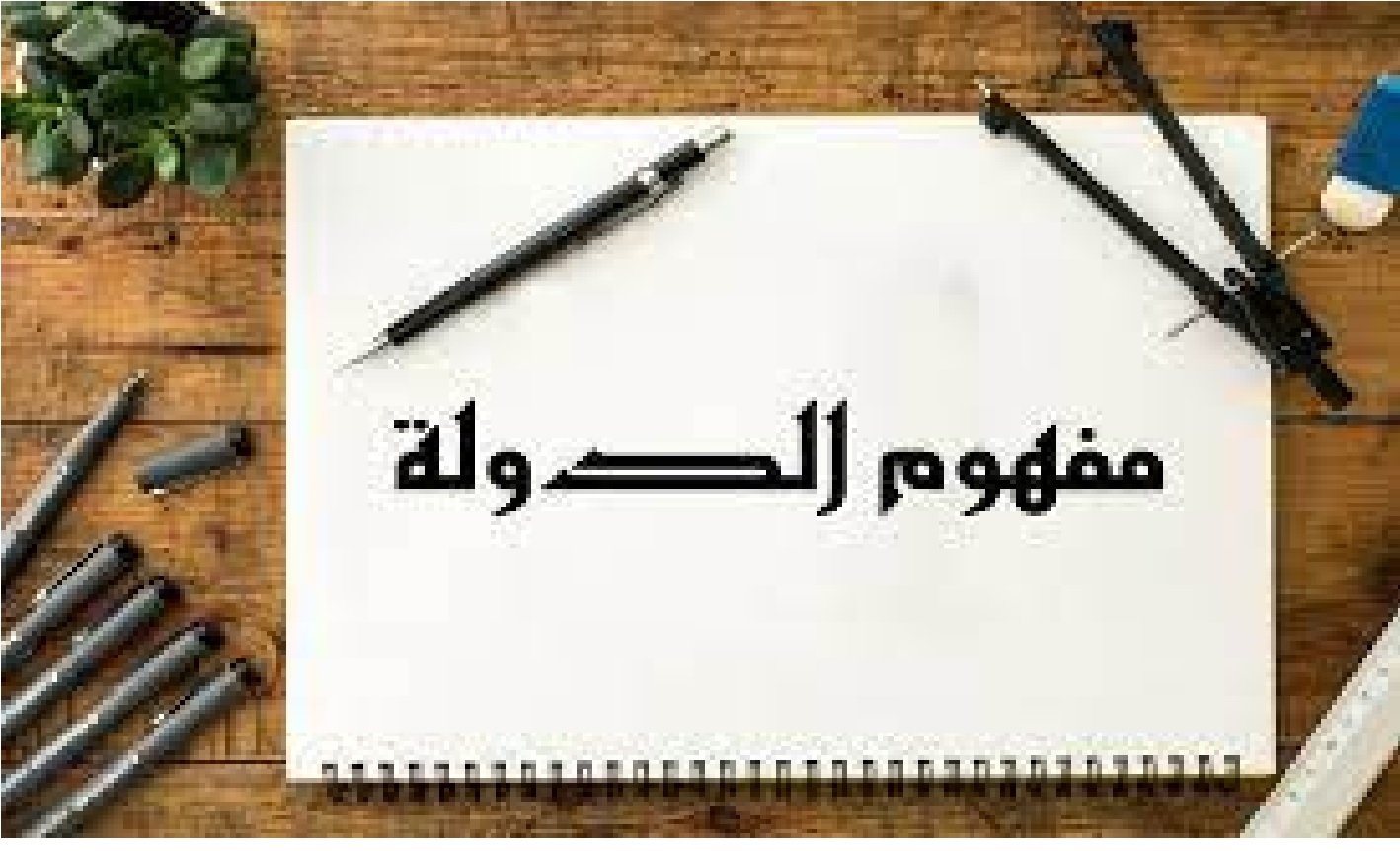تمغربيت:
ينحو ماكس فيبر منحى “المغالاة في وصف المظاهر المميزة: قد تكون جنينية فنجعلها كاملة تامة، قد تكون ممزوجة بغيرها فنعتبرها صافية” (ص 71)، تتطلب طريقته “مقابلة حالتين: الأولى إيجابية والثانية سلبية. وإذا كنا نتوخى فرز ظاهرة اجتماعية لنركب نموذجها الذهني، فلا بد من انتقاء مثل تاريخي يتضمنها ومثل آخر يجهلها. فنتوصل إلى إظهار آثار وجودها في الأول وآثار غيابها في الثاني. وبمقابلة النتائج الإيجابية والنتائج السلبية نوضح عناصر النموذج المنشود” (ص 71، ص 63).
إن طريقة فيبر حسب العروي، هي بتعبير آخر “تعتمد التطرف المنهجي لكي تلمس العنصر المهم في الظاهرة المدروسة، فهي بمثابة مجهر يمكننا من إدراك الواقع من خلال تفخيم مكوناته” (ص 64).
واختار العروي الصراع بين فرنسا النابوليونية (المثل الإيجابي) وأوروبا الأرستقراطية (المثل السلبي).. مثالا لاختبار التطرف المنهجي لدى ماكس فيبر (ص 63-64). هما، إذن، نموذجان للدراسة، الدولة النابوليونية والدولة النمساوية. لإظهار الفرق بينهما، عمِل العروي على وصف التحديث الذي أشرف عليه نابليون في فرنسا، ثم قارنه بالوضع الذي كانت عليه النمسا الأرستقراطية. لم تكن فرنسا نابليون دولة محض حديثة، ولم تكن النمسا الأرستقراطية دولة محض تقليدية، إلا أن “الطريقة الفيبرية تحمل بين طياتها “نفعا منهجيا يُمكن الباحث من التركيز على الهدف الذي يتجه إليه التطور”. (الصفحات: 63، 64، 73)
يقول العروي: “لم تصل أية دولة في التاريخ إلى صفاء الدولة الحديثة ولم تبق أية دولة حاليا وفية تماما للدولة التقليدية، لكن بمقارنة الاثنين ندرك مسار التاريخ منذ عصر النهضة”. فهل بإمكان الباحث الحكم بحداثة دولة ما دون تصور أخرى تقليدية؟.. وهل بإمكانه الحكم على تقليدانية دولة ما دن تصور أخرى حديثة؟
في هذا السياق، يجيب العروي “عندما نحكم على هذه الدولة أنها عصرية وعلى تلك أنها تقليدية.. فإننا نتمثل أحد النموذجين كمعيار، وعينا ذلك أم لا. ولقد تمثل ماكيافلي دولة فرنسا الموحدة المنظمة ذات الجيش القوي عندما بكى حظ إيطاليا المجزأة المبعثرة المستغلة من طرف جيوش المرتزقة. كما تمثل هيجل دولة نابليون عندما حكم على ألمانيا بأنها ما زالت إمبراطورية بعيدة عن أن تكون دولة بمعنى حديث.” (ص 73)
نفس المنهج يصدق على العروي نفسه، يتمثل حداثة الدول الغربية عندما ينظر إلى تقليدانية الدولة العربية (الإيديولوجيا العربية المعاصرة).. يتمثل عقل الحداثة عندما يبكي “العقل المطلق” (مفهوم العقل).. ويتمثل “نظرية الغرب” عندما يقارنها ب”طوبى العرب” (مفهوم الحرية، مفهوم الدولة)؛ إلخ. وهكذا، تتم المقارنة بين جيش وجيش، قانون وقانون، إدارة وإدارة، اقتصاد واقتصاد، تعليم وتعليم، إلخ.
وربما هذا ما استحضره العروي وهو يدرس مراحل التحديث في فرنسا النابوليونية.. يندب حظ الوطن العربي إذ لم يحظ بواقع سياسي كالذي أفرز تجربة نابليون وهيأ الظروف والشروط لنجاحها.. كل هذا مهم، وأهم منه أن “فيبر هو الذي وضع في قلب العلوم الإنسانية المعاصرة ذاك الثنائي المشهور: الحداثة والتقليد” (ص 77). لولا مغالاة فيبر المنهجية لما تبلورت هذه الثنائية، ولما فكر العروي في واقعنا على ضوء الواقع الغربي.